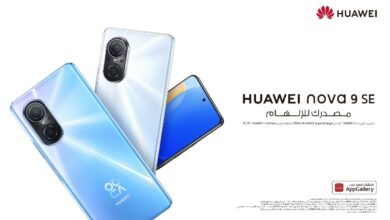“التفكير بالتعاطي مع التظاهرات بمنطقِ كسر الإرادات، كانت نتيجته خسارة لأحزاب السلطة”
الكاتب : د. اياد العنبر
“ليهتف المتظاهرون بسقوط المسؤول أو بنجاحه. وليهتف المتظاهرون بما يطالبون من أمور مقبولة وغير مقبولة، فالمسألة ليس أن نختلف أو نتفق حول الشعارات. بل احترام الرأي… حرية التظاهر حق كحرية الإعلام والتعبير والأحزاب وغيرها من حريات كفلها الدستور. ومن واجب قوات الأمن حماية المتظاهرين لا تسديد فوهات البنادق ضدهم”.
قد يتوهم من يقرأ هذه النصوص، أنها تعود لجون ستيورات مِل في كتابه “عن الحرية”، أو أنها تعود لإيزايا برلين في كتابه “الحرية”. لكنها بالحقيقة جزء من مقالات كتبها السيد عادل عبد المهدي رئيس الوزراء في افتتاحيات جريدة العدالة تعليقا على تظاهرات فبراير 2011.
نعم، عبد المهدي الذي لم يقدّم استقالته من رئاسة الحكومة إلا بعد أن تجاوزت أعداد ضحايا ساحات التظاهر المئات بين شهيدٍ وجريح!
ويبدو أن عبد المهدي تمكّن من خداع الطبقة السياسية مرّة بطروحاته وتنظيراته، ومرّة ثانية بالتعامل معها بمنطق التخادم المصلحي، من خلال جعل تحقيق مصالحها مرتبطة بوجوده على رأس الحكومة. ويتّضح ذلك من خلال تمسك الكثير من قوى السياسية الشيعية ببقائه بالمنصب، إضافة إلى القوى الكرديّة، وبعض القوى السنيّة، متجاهلة عجزه عن إدارة أزمة التظاهرات.
الموضوع الرئيس لا يتعلق بنقد شخص السيد عبد المهدي، رغم أنه أثبت وبجدارة فشله في إدارة الدولة، وإنما نقد تفكير المنظومة السياسية التي يُعد عادل عبد المهدي أنموذجا لها. فحكومته بفشلها وسوء إدارتها تعبّر عن تراكمات الأخطاء التي أنتجها التفكير المأزوم للطبقة السياسية. فبينما نحن نقترب من بلوغ السنة السابعة عشر على تغيير النظام السياسي في العراق، فإن منظومة التفكير السياسي لم تتمكن من التفكير بإدارة التوازن بين رغبة الوصول إلى السلطة والاستجابة لمطالبِ الجمهور، إلا بالقدر المتعلّق بإدارة الصفقات السياسية التي تضمن البقاء في دائرتَي السلطة والنفوذ.
ولم تكن تظاهرات أكتوبر إلا كاشفة لأزمة القيادة السياسية في العراق، ولعلَّ غياب أفق الحل السياسي والتعاطي مع التظاهرات من أبرز ملامح تلك الأزمة. إذ يبدو أن أحزاب السلطة لم تغادر مرحلة المراهقة السياسية والانتقال إلى مرحلة العمل السياسي القائم على إدارة التوازنات وليس محاولة كسر الإرادات.
فلطالما كان محور اهتمام القوى السياسية منصبّا في ترسيخ البقاء بالحكم من خلال الهيمنة على مؤسسات الدولة والسيطرة على الإعلام وخداع الرأي العام بعناوين الطائفة والمذهب والقومية، ومن ثم توسيع دائرة الزبائنية السياسية لضمان الفوز في الانتخابات. وما عدا تلك المواضيع لم يجرِ أي نقاش بشأن ما يطالب به المواطن. وأي دولة نريد بنائها؟ إلا في اللقاءات الصحفيّة لزعماء الطبقة السياسية.
ومنذ اليوم الأول للتظاهرات، كان إدراك القوى السياسية أن مطالب المحتجّين مشروعة ومحقّة، وأنها تعبير عن تردي الأوضاع المعيشية وتراكمات الفساد وسوء الإدارة. لكنها لم تعتبرها فرصة لتصحيح المسار والاحتفاظ بزمام المبادرة من خلال تقديم الضغط على الحكومة لتقديم الاستقالة أو إقالتها، لامتصاص السخط الجماهيري من ساحات التظاهر، لا سيما بعد أن ملأت الساحة بدماء المتظاهرين. لكنَّ الطبقة السياسية أصرّت على التفكير بمنطق القبيلة لا الدولة، واعتبار أي تقديم للتنازلات بوابة لتنازلات أخرى قد تُهدد مصالحها!
إذا، تحمّلت العملية السياسية كثيرا من المفارقات، أبرزها اتساع الفجوة بين المجتمع والسلطة. وكلما كان هناك تقادم ممارسة العمل السياسي، لكن النظام السياسي في العراق المعنوَنِ بالديمقراطية يُدار بوساطة طبقة من الحكام الأوليغارشيين الذين يحكمون بمسمى الديمقراطية.
وإذا دققنا بالموضوعِ أكثر، نجد أن القوى السياسية تفتقد للنضجِ السياسي الذي يؤهلها لإدارة أزمات الحكم! كيف لا، وهي طوال الفترة الماضية تسوّي خلافتها، ولا تعقد اجتماعاتها للتفاوض لتشكيل الحكومة والقبول بالمرشحين للمناصب العليا في الدولة إلا تحت رعاية القادمين من وراء الحدود، والتي كانت تدير الصفقات السياسية لتمرير المرشحين، وعندما رحل عرّاب التوافقات عن المشهد السياسي في العراق ظهرت عورات التوافقات السياسية.
وبجردة حساب للمواقف السياسية، منذ بدء التظاهرات حتى يومنا هذا، نجد أن غياب القيادة السياسية ما هو إلا تعبير عن عامل إضافي للفشل الذي أصبح علامة فارقة في تاريخ أحزاب السلطة السياسية في العراق. والموضوع لا يحتاج إلى الأدلة والبراهين، فأزمة الاتفاق على شخصية سياسية تتمتع بنسبة بسيطة من المقبولية، ويكون محلّ توافق بين جمهور من المتظاهرين وبين القوى السياسية، إنما هي أزمة تمثل دليلا واضحا على عجز النظام السياسي الراهن عن إنتاج قيادات سياسية.
ولا تزال الطبقة السياسية تعتقد أن حركة الاحتجاجات ينحصر تأثيرها على الطبقة السياسية الشيعية، وقد يكون ذلك صحيحا بسبب عجز السياسيين الشيعة عن تحويل التحدي الذي فرضته التظاهرات إلى فرصة للمُضي بإصلاحات حقيقة للنظام السياسي، إذ أنها فرصة تستبطنها حركات الاحتجاجات لتعزيز مشروعية النظام.
بيد أن تصدّع النظام السياسي أمام حركة الاحتجاجات يؤشّر على المدى القريب لنهاية النظام، إذ بات تغيير شكل النظام المحاولة الأخيرة التي يمكن من خلالها إنقاذه من تغيير شامل وجذري، وقد يكون بطريقة بعيدة عن الآليات الديمقراطية.
لقد حاولت الطبقةُ السياسية الاستمرار بالتسويفِ والمماطلة، ولعلّها تطيل بعمر حكومة عبد المهدي، والتي اعتبرت تغييرها بمثابة كسر لإرادة أحزاب السلطة. وهنا أيضا أثبتت خطأها في قراءة حركة الاحتجاجات. فالاحتجاجات لم تخرج من أجل إسقاط الحكومة فحسب، بل هي تهدف إلى إنهاء المنظومة السياسية القائمة على خدمة أحزابِ السلطة ومَن يتبعهم.
التفكير بالتعاطي مع التظاهرات بمنطقِ كسر الإرادات، كانت نتيجته خسارة لأحزاب السلطة. وربما تكون هذه النتيجة غير واضحة المعالم على المدى القريب، لأنها تبقى مرتهنة لقدرة ساحات التظاهر على تسخير جهودها في تنظيم مشاركتها السياسية في الانتخابات القادمة، وعقلنة مطالبها في هذه الفترة من خلال تحديدها بخارطة طريق تبدأ بالإصرار على تحديد موعد للانتخابات المبكّرة، والعمل على بلورة تيارات سياسية من الجيل الشبابي الذي كان فاعلا في ساحات التظاهر، ويكون قادرا على كسب تأييد الكثير من القطاعات الشعبية التي فقدت ثقتها بالديمقراطية وإصلاح النظام السياسي.