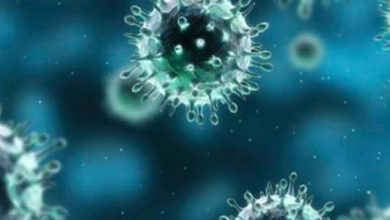” إنّ تراث الأمم هو رصيدها الباقي”
الكاتب : مصطفى الفقي
تتشكّل الفنون وفقاً لهُوية الأمم، وتمضي الآداب مع شخصية الشعوب، ولقد عشتُ في الهند سنوات أربع خلال حياتي الدبلوماسية، واكتشفت أن المكون الثقافي للأمة الهندية هو الذي يحدد هُويتها وشخصيتها مركزاً على الفنون والآداب من أغانٍ، ورقصات، وأزياء، وعادات وتقاليد، فضلاً عن التجانس في المأكل والمشرب، وهذه كلها مكونات طبيعية للشخصية القومية.
ونحن العرب في هذه المنطقة من العالم نبدو أحوج ما نكون إلى ذلك الرصيد المتراكم عبر تاريخنا الطويل بصورة تضمن إحياء الثوابت الإيجابية والتخلص من التقاليد البالية والأفكار التي لم تعد مواكبة روح العصر أو المزاج العام للأجيال الجديدة.
فالعربي عندما يستمع إلى أم كلثوم أو فيروز أو عبد الوهاب أو وديع الصافي أو محمد عبده فإنه يدرك أهمية المشترك الثقافي في تكوينه، ويدرك أن التجانس لا يأتي من فراغ، لكنه يتشكّل نتيجة الهُوية الواحدة والشخصية التي تستمد روحها من تجليات التاريخ وميزات الجغرافيا.
ونحن في هذه المنطقة من العالم نجد بلادنا في بؤرة الإبداع الذي تتداخل فيه حضارات البحر المتوسط، وثقافات الشرق الأوسط، وديانات أهل الكتاب، لذلك فإننا نتميز بالثراء الثقافي والتعددية الفكرية.
إننا ورثة الحضارات الكبرى والثقافات التي صنعت في النهاية تلك السبيكة العربية التي ننفرد بها وننتمي إليها، ولعلي أطرح هنا بعض الأفكار المرتبطة بالعلاقة بين الفن والأدب من ناحية، وبين الشخصية القومية من ناحية أخرى:
أولاً: الفن هو تعبير عن النسب المختلفة في التكوين الجمالي سواء بالرسم أو النحت أو بالموسيقى أو بالغناء أو غيرها، وهي التي تنقلنا من عالم الواقع بآلامه إلى واقع أسطوري مختلف بأحلامه ورقته وسموه.
فالفن لغة إنسانية وتعبير عميق يتعاطاه البشر لكي يرتفع بهم إلى مراتب عليا من التأمل الذكي والإحساس العميق بالسعادة والرغبة في أن تظل الأمور دائماً في إطارها المطلوب، فالحياة في النهاية محنة واختبار والفن ارتقاء وازدهار، ولقد عشت في نيودلهي سنوات دبلوماسياً في السفارة المصرية في مطلع سبعينيات القرن الماضي، وبهرني من الفنون ومظاهر الحياة أن لهم طعامهم وشرابهم، وأن لهم أزياءهم المتميزة رجالاً ونساءً، وأن لهم أغانيهم وموسيقاهم ورقصاتهم التي يتميزون بها وينفردون بالانتماء إليها.
وأدركت كثيراً، لماذا الأمة الهندية متماسكة رغم اختلاف اللغات والثقافات والديانات؟ إذ يجمعهم إطار واحد لفنون السينما والمسرح الغنائي والنحت بكل أشكاله، إنّ الثقافة الهندية كما أسلفنا هي ظاهرة آسيوية عالمية.
ثانياً: إنّ تراث الأمم هو رصيدها الباقي، وهو ما تعتمد عليه في مواجهة غيرها وتتميز به عن سواها، ولا يمكن أن تنقطع جذور أمة عن تراثها العريق، ثم تصبح بعد ذلك شيئاً مذكوراً، لكن التراث لا يتعارض مع الحداثة، ولا يصطدم بالتجديد، بل إنّ الالتزام الأشد بالتراث يؤدي بالضرورة إلى تألق روح الحداثة ومفهوم التجديد والشواهد على ذلك كثيرة، إذ لا مستقبل لأمة ليس لها ماض، ولا تألق لشعب ليس له تراث.
ثالثاً: إنّ الفنون والآداب هما ركيزتان للثقافة بمدلولها العام، ولذلك فهما يصنعان حالة الانصهار الوطني والانسجام الجماعي لدى الدول المختلفة، بل وفي إطار الأمة الواحدة مهما تعددت أقطارها، فالثقافة هي لغة الوجدان وهي التعبير الأسمى عن معنى الوحدة ودلالة الاندماج، ولا يمكن أن نقلل أبداً من شأنها، لأنها مصدر الثراء الأول، وهي التعبير الأدق عن الروح والمشاعر والأحاسيس بكل جوانبها وتجلياتها.
ان الفنون والآداب، والأشعار والأذكار، والرسم والنحت، والسينما والمسرح هي كلها نماذج حية للمشترك الثقافي والعقل الجمعي والوجدان الواحد لأي جماعة بشرية عبر التاريخ، وإذا طبقنا ذلك علينا نحن العرب فسوف نجد أننا كنا ولا نزال حراساً للتراث وحماةً لما آل إلينا من معرفة وعلم، ومن فن وأدب، ومن فكر وثقافة.
رابعاً: إذا أردت أن تعرف قيمة أمة واحدة، وأن تختبر هُويتها الحقيقية فما عليك إلا أن تطرق أبواب مسارحها ودور السينما فيها، وقاعات الرسم وصالات النحت، وأن تستمع إلى الموسيقى الوطنية لتلك الأمة، فالموسيقى لغة عالمية، وهي تهذيب للنفس وارتفاع بالذات نحو المدارج العليا لما يمكن أن يتطلع نحوه الإنسان أو يسمو إليه.
ولقد عرفنا عبر تاريخنا الطويل كيف أن تراثنا امتدّ من حدود فيينا شرقاً إلى الأندلس غرباً وعبر على كل جزر المتوسط، وامتد من شرق وأواسط آسيا إلى غرب ووسط أفريقيا تأكيداً لشموخ حضاري وتعدد ثقافي في ظل إطار واحد لا ينكر أهمية الإنسان سيد الكائنات وخليفة الله في الأرض.
خامساً: إنّ مستقبل الفنون العربية والآداب القومية في ظل التراث الإسلامي المسيحي الذي تتميز به غرب آسيا وشمال إفريقيا يدعونا دائماً إلى الاهتمام بالأثر الثقافي متمثلاً في القدرة على محاكاة الواقع، واستشراف المستقبل وازدهار الخيال.
فالفنون والآداب هما جناحان للأفق الرحب والخيال العريض، ومن دونهما لا تستقيم الأمور، ولا تتحدد مظاهر الحياة، لذلك عكف العرب عبر التاريخ على لغة الشعر، واعتبروه ديوان العربية الحقيقي، وتجاوبوا معه وزادوا فيه، ورغم اختلاط الثقافات المعاصرة وتواصل الحضارات المزدهرة فإننا لا ننكر أبداً أن العروبة حافظت على شخصيتها، وأن الثقافة فيها تميّزت عن غيرها من دون تعصب أو انغلاق أو شيفونية.
بل لقد آمنا دائماً بأن الدين لله، وأن الوطن للجميع، كما أدركنا مبكراً أهمية الآداب والفنون في حياتنا، وتعلّمنا أن ثقافات الشعوب وحضارات الأمم هي رصيدها الباقي، وامتدادها من الماضي إلى المستقبل عبوراً على الحاضر.
سادساً: إنّ المنطقة العربية هي وريثة لحضارات قديمة وثقافات متعددة بدءاً من الفرعونية إلى الإغريقية والرومانية مروراً بالفينيقية والبابلية، وصولاً إلى أصحاب الثقافات القديمة والأقوام المندثرة، لذلك كانت المحصلة دائماً ثرية ومتنوعة، وتبدو كالسبيكة التي نعتز بها ونسعد بوجودها، وندرك أنها هويتنا وشخصيتنا والتعبير الصحيح عن تراثنا وتاريخه.
سابعاً: إنني أكتب هذه السطور لكي أسجّل أمام الأشقاء العرب أنه مهما كانت اختلافاتنا، ومهما وصلت صراعاتنا إلا أن شيئاً قوياً يجمعنا وتراثاً عريقاً يشدنا، وهو يقوم على الدعوات المتحضرة لبعض النماذج العربية التي حاولت احتواء الأقليات العددية، وحملت أسماء يهودية ومسيحية ومسلمة.
إنها نداءات من أمثال جبران خليل جبران، وداوود حسني، وعبد الوهاب، وأم كلثوم، وفيروز، وفريد الأطرش، وليلى مراد، وصباح ومدارسها الفنية المعاصرة، حتى يدرك الجميع أننا نمضي على طريق واحد، ونعبر جسراً مشتركاً، يأخذنا إلى المستقبل في أفضل صوره، وأوسع خيالاته، وأرقى تصوراته.
هذه رؤيتنا للقوى العربية الناعمة التي يمكن أن نرتكز عليها، وأن نعتمد على وجودها، ويكفي أن نقول إن إسرائيل ما زالت تقوم بعملية سطو ثقافي على تراثنا العربي حتى امتد الأمر إلى الطعام والشراب، فزعموا أن الفلافل إسرائيلية، وأن بناة الأهرام يهود، واستغرقوا في الأكاذيب بلا حدود من دون سند من تاريخ أو حجة من تراث.
لكن يقظة العرب وحساسية الفلسطينيين جعلتهم يدركون الأمر، ويستميتون من أجل الأرض، ويتسابقون في حماية التراث والحفاظ على الهُوية، إنّ الفن والأدب هما جناحان للثقافة العربية التي تحلق في فضاء المنطقة عبر السنين، وهما اللغة المشتركة في أثناء المحن والأزمات وأمام كل التحديات.